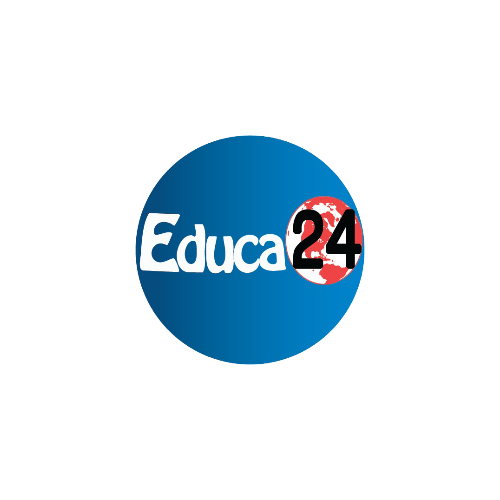مقدمة
من بين عناصر القوة في أي مشروع تربوي وطني، يبرز التأطير الميداني والقيادة القريبة من القسم باعتبارهما المحركين الحقيقيين لتغيير الممارسات الصفّية.
فإذا كانت المرحلة الأولى من تجربة مدارس الريادة قد كشفت أهمية تكوين الأساتذة التعليم الصريح (Enseignement explicite) ودعم التعلمات الأساس ، فإن مرحلة التعميم بيّنت أن مفتاح النجاح لا يكمن في حجم التكوينات أو التجهيزات، بل في خلق بنية مهنية داخلية قادرة على ضمان المواكبة اليومية، وهي الوظيفة التي جسدها نموذج الأستاذ المنسق.
1. من التأطير الإداري إلى القيادة البيداغوجية الميدانية
عرف النظام التعليمي المغربي لعقود نمطا هرميا في التأطير، يعتمد على المفتش التربوي كفاعل وحيد في المواكبة والتقويم.
لكن في ظل تعميم مدارس الريادة، لم يعد هذا النموذج كافيا ولا واقعيا ، فعدد المؤسسات والأقسام يفوق بكثير طاقة التغطية الميدانية للمفتشين.
لهذا، جاء نموذج الأستاذ المنسق كتحول نوعي من “القيادة الإشرافية” إلى “القيادة التشاركية الميدانية”
هذه المقاربة هي ممارسة عالمية
ففي كينيا مثلا ، أسهمت شبكة Teacher Coaches في نجاح برنامج Tusome الوطني للقراءة المبكرة.
وفي كندا، اعتمدت مقاطعة أونتاريو على Lead Teachers كحل لتوسيع تجربة Right to Read، مما رفع نسب الفهم القرائي بنسبة 20٪ خلال ثلاث سنوات.
إذن، فالمغرب يسير ضمن الاتجاه الصحيح: اللامركزية المهنية للمواكبة.
2. التكوين والمواكبة من الداخل: منطق الكلفة والفعالية
من منظور الاقتصاد التربوي، تكوين الأساتذة عبر المنسقين أكثر كفاءة واستدامة من التكوينات المركزية.
فالتكوين الداخلي يخفض الكلفة بنسبة تقارب 40٪ مقارنة بالتكوينات التقليدية، ويضمن في المقابل أثرا أطول وأعمق لأن المرافقة تتم داخل السياق الطبيعي للعمل.
وقد أثبتت تقارير الأكاديميات الجهوية خلال 2024–2025 أن المنسقين تمكنوا من تغطية جميع المؤسسات المندرجة ضمن الريادة، مما يجعل الادعاء بضعف التأطير غير مستند إلى الواقع الراهن.
بل إن الوزارة، عبر تكوين هؤلاء المنسقين وتمكينهم من أدوات التتبع، خلقت طبقة قيادية جديدة داخل المدرسة،
تجمع بين الخبرة الصفّية والمعرفة البيداغوجية، مما يجعلها المحرك العملي لتعميم الريادة وضمان استدامتها.
3. ضرورة مأسسة وظيفة الأستاذ المنسق
ورغم نجاح التجربة ميدانيا، فإن مستقبلها يقتضي الانتقال من الطابع التجريبي إلى التقنين الرسمي.
فغياب الصفة القانونية الواضحة قد يحد من استمرارية الدور ، ويؤدي إلى تفاوت بين المؤسسات في الأداء والتغطية.
إن مأسسة وظيفة الأستاذ المنسق ينبغي أن تشمل:
تحديد مهامه في المذكرات التنظيمية: المواكبة الصفية، تتبع مؤشرات الأداء، وتيسير التكوينات المصغرة.
تحديد نطاق الإشراف (10–15 أستاذا كحد أقصى).
اعتماد نظام تعويض دوري مشروط بالأداء
تمكينه من المشاركة في اجتماعات القيادة التربوية على مستوى المديرية
بهذه الخطوة، يتحول المنسق من حل مؤقت إلى فاعل مؤسساتي يضمن انتظام الإصلاح، ويربط الممارسة الصفية بالتخطيط الجهوي والوطني.
4. المنسق كحل لندرة التأطير التقليدي
إن القول بأن تعميم الريادة يصطدم بنقص المؤطرين يغفل أن الوزارة تبنت فعلا حلا هيكليا لهذه المعضلة:
المنسق التربوي ليس “مؤطرا بالوكالة”، بل قائد ميداني ضمن المؤسسة نفسها،
يعمل في منطق “التأطير الأفقي” الذي يكمل “التأطير العمودي” للمفتشين.
وقد أثبتت هذه البنية المزدوجة (مفتش–منسق) فعاليتها في ضمان استمرارية الدعم، خصوصا في المناطق القروية،
5. نحو رؤية جديدة للقيادة المدرسية
تجربة المنسق ليست فقط آلية لتدبير الخصاص، بل هي تصور جديد للقيادة المدرسية، يقوم على تحويل المدرسة إلى منظمة متعلمة تمتلك مواردها البشرية الداخلية للتطوير الذاتي.
فالمدرسة التي يتوافر فيها منسق فعّال لا تحتاج انتظار زيارات التفتيش لتصحيح الممارسة، بل تنتج خبرتها التربوية الخاصة وتشاركها أفقيا بين الأساتذة. هذا التحول يجسد فلسفة مدرسة تتعلم لتعلّم، وهو ما يجعل “الأستاذ المنسق” الركيزة الأساسية لاستدامة مدارس الريادة.
خاتمة
إن نجاح تعميم مدارس الريادة لا يتوقف على ضخ الموارد أو تعديل البرامج، بل على بناء قيادة تربوية لامركزية تنبع من داخل المؤسسة التعليمية نفسها. ولذلك فإن تقنين وظيفة الأستاذ المنسق لم يعد خيارا تنظيميا،بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة التعلمات الأساس واستدامة الإصلاح. تغافل هذا المعطى، كما تظهر التجارب المقارنة، قد يؤدي فعليًا إلى إفراغ الإصلاح من روحه، بينما الاعتراف القانوني والمادي بهذا الدور سيضمن للمغرب نموذجا فريدا في القيادة التربوية الذكية والمستدامة