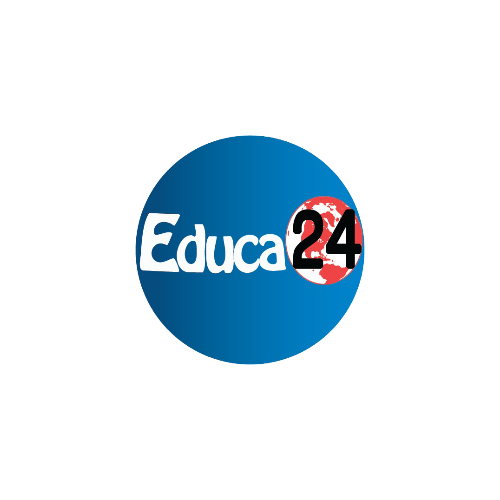مع بداية الدخول المدرسي، يتحول البلد إلى مسرح عبثي مفتوح على كل الاحتمالات. روائح الكتب والدفاتر تفوح في الأزقة كأنها بخور لطقوس جماعية، والمكتبات الرسمية تضيق عن استيعاب الزبائن، فتتطوع محلات البقالة التي كانت حتى الأمس القريب تبيع نصف خبزة وعلبة سردين لتتحول إلى مكتبات طارئة، تعرض دفاتر ملونة وأقلامًا براقة وكراريس مشكوك في جودتها. مشهد يشبه حالة طوارئ وطنية، لكن دون إعلان رسمي: كل شيء مباح، وكل شيء يباع، والزبون الأول والأخير هو ولي أمر يجر خلفه أبناءه كأنهم في طريقهم إلى معسكر تجنيد لا إلى مؤسسة تعليمية.
الأطفال أنفسهم يدخلون الطقس ببراءة مغشوشة: أجساد نحيلة لا تقوى على حمل محافظ بوزن فيل، وظهور صغيرة تنحني مبكرًا تحت ثقل أوراق لا يقرؤونها. في الشارع يخيل للناظر أن الحقيبة تسير وحدها بينما الطفل مجرد ظل مضاف إليها. مشهد من فرط غرابته يصلح لإعلان تجاري عن قوة المحافظ المغربية، لكنه في الحقيقة شهادة دامغة على هشاشة الجسد الذي يُفترض أن يحمل أحلام المستقبل.
أما النقل المدرسي فذلك فصل آخر من الكوميديا السوداء. حافلات صفراء تتحرك بسرعة غير مبررة وسط الأزقة الضيقة، يقودها سائقون يتقمصون شخصية “خطافة البلايص”، وكأن السباق أهم من الأرواح الصغيرة المحشورة في الداخل. أبواب توشك أن تطير مع أول مطب، وأطفال يتشبثون بالمقاعد كأنهم أبطال في مشهد من فيلم أكشن رديء، بينما الدولة تغض الطرف وكأنها تكتفي بدور المتفرج: المهم أن الضجيج يصل إلى المسامع ليقنعنا بأن “التعليم بخير”.
ثم تأتي المدارس الخصوصية لتكمل الحكاية. لوائح مستلزمات أطول من قائمة عرس، ورسوم تسجيل أشبه بمهر غامض لا يعرف أحد على أي عروس يُدفع. أقلام ملونة، أوراق مطلية، دفاتر بأحجام هندسية، وطلبات عبثية مثل “ملف أزرق من النوع الممتاز”، كأن مستقبل الطفل يتوقف على نوعية البلاستيك المستعمل في الملف. وفي النهاية، ما يُشترى لا يُستعمل، وما يُستعمل لا يغير شيئًا في مستوى التلميذ الذي سيظل عالقًا بين لغة أجنبية لا يتقنها وأستاذ مثقل بالحصص.
الآباء والأمهات بدورهم يخرجون من هذه التجربة مثقوبين الجيوب، منهكين الأعصاب، مهددين بالسكري والضغط الدموي. الدخول المدرسي عندنا ليس بداية أمل جديد، بل مناسبة رسمية لتجديد عقد الألم مع السوق والدولة في آن واحد. مشهد يضعنا أمام صورة مصغرة عن البلاد: نظام يخلط بين التعليم كتربية وبين التعليم كتجارة، بين المدرسة كفضاء لصناعة الإنسان والمدرسة كسوق لتصريف السلع.
إنه الدخول المدرسي الذي لا يعلّم بقدر ما يفضح: يفضح هشاشة الأسر، جشع المؤسسات، عبثية البنية التحتية، ولامبالاة الدولة. موسم أشبه بمرض موسمي يضرب العائلات كل شتنبر، حيث ترتفع نسب الضغط الدموي والسكري والصداع النصفي، وربما البوحمرون أيضًا، قبل أن يتعوّد الناس من جديد على الألم كعادة وطنية لا تحتاج إلى تفسير.
لكن المسرحية لا تقف عند هذا الحد. التلميذ يبدأ العام بحقيبة تساوي نصف وزنه وينهيه بشهادة لا تساوي ثمن الدفاتر التي اشتراها. الأستاذ يدخل القسم وهو يجر خيبته مثلما يجر الطفل محفظته، يكتب على سبورة بيضاء فيما المستقبل يزداد سوادًا. الآباء يتنقلون بين المكتبات والبقالات، بين الحافلة والباب الحديدي للمدرسة، بين القرض والدين، ليكتشفوا أن ما دفعوه لم يكن ثمن تعليم بل تذكرة حضور في مسرحية قديمة. والدولة؟ تكتفي بالتصفيق من بعيد، تنشر بلاغات رسمية تشبه أوراق الدفاتر الرديئة: جميلة من الخارج، فارغة من الداخل.
نحن لا ندخل موسمًا دراسيًا جديدًا، بل غرفة انتظار جماعية حيث يشيخ الأطفال قبل الأوان، ويتحول التعليم إلى سبب إضافي للمرض بدل أن يكون الدواء. بلد يضع كل عام ثقله على أكتاف صغاره، ثم يستغرب لماذا ينحنون مبكرًا، ولماذا يكبرون وهم يجرون وراءهم ظهرًا محنيًا وأحلامًا مكسورة.
وهكذا، بدل أن يرنّ الجرس ليعلن بداية رحلة التعلم، يرنّ في أعماقنا ناقوس آخر: أن المدرسة ليست سوى مرآة تكشف ما لا نحب أن نعترف به. أننا بلد يعلّق المستقبل في محافظ ثقيلة على أكتاف أطفال نحيلة، ثم يتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. لذلك، حين نرى التلاميذ بعيون نصف مغلقة وظهور منحنية يحملون محافظهم، ربما أصدق ما نسمعه ليس ضحكاتهم المتعبة، بل السؤال الصامت الذي يوجهونه لنا جميعًا: هل أنتم متأكدون أن هذا ما تسمونه مستقبلًا؟