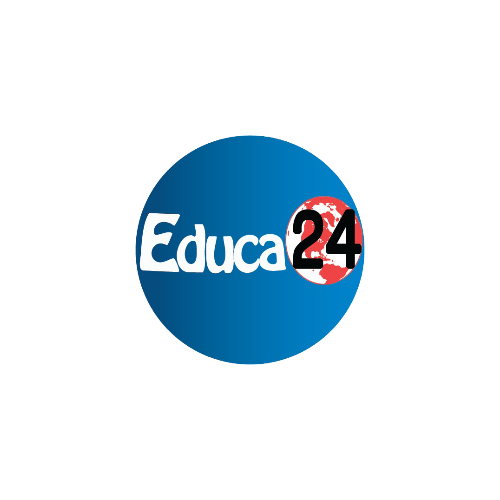أوّل ما يتبادر إلى أذهانِنا هو سؤال: "كيف نجعل المدرسة مكاناً يشتاقُ إليه أبناؤنا؟". فهل تساءلتَ يوماً ما الذي نستطيعُ القيام به نحن الأهل والمعلّمون لكي نحوّل المدرسة من مكانٍ يثير النفور إلى مكانٍ يتشوّق أطفالنا إلى الذهاب إليه كلّ صباح؟ لا يكمن الحلّ هنا في إجبارِهم، أو التحايلِ عليهم، أو حتى إغرائهم بالمكافآت لتقبُّل الواقع المرير، بل في تعزيز دافعيّتهم الطبيعيّة وحبّهم الفطري للتعلّم! في ما يلي أبرز المسبّبات لهذه المشكلة، وبعض الحلول لتفاديها.
ما الأسباب الحقيقيّة وراء نفور أبنائنا من المدرسة؟ نظرة إلى المشكلة من الجذور لكي نجيب عن هذا السؤال، وقبل أن نبحث عن الحلّ، يجب أن نتوقّف ونسأل بصدق عن الأسبابِ الحقيقيّةِ وراء نفورِ الأبناء وعدم حبّهم للمدرسة. فهل المشكلة في المدرسة بحدّ ذاتها كمؤسّسة؟ أم في ضعف تحفيز الأهل لأولادهم كفايةً؟ أم في أسلوب تعامل المعلّمين مع الطلاب؟
كشفت دراسة ضخمة أجرتها جامعة "ييل" في عام 2020 أنّ قُرابة 75% من طلاب المرحلة الثانوية، أبدوا مشاعر سلبيّة تجاه المدرسة، بما في ذلك الملل والتعب والقلق، مما يؤكّد أنّنا نواجه أزمةً حقيقيّةً في دافعيّة أبنائنا إلى الدراسة، وقد يكون للأهل دورٌ غير مقصود في تعزيز هذا النفور.
في ما يلي أبرز الأسباب التي تؤدّي إلى تملمُل أبنائنا من المدرسة.
- التركيز على الحفظ والتلقين بدل التعلّم النّشِط ما تزال المناهج التعليميّة في معظم مدارسنا تعتمد على أحاديّة التواصل في الصفّ؛ إذ يوجّه المعلّم التعليمات، ويشرح الدرس، ويطرح الأسئلة للطلاب بدلاً من اعتماد أسلوب الحوار والاستكشاف والتجربة، ممّا يُفقد الأطفال شغف التعلّم، فيشعرون بالملل والضغط.
تخيَّل أن تقضي سبع ساعات يومياً في مكان لا يحفّز تفكيرك؛ حيث تستمع إلى محاضرات متتالية، وتحلّ واجبات متشابهة إلى حدّ كبير، وتشعر وكأنَّك تعيد اليوم ذاته طيلة العام الدراسي.
يُعد هذا الشعور بالملل خطيراً؛ لأنّه يُطفئ الفضول والدافعيّة الفطريّة للتعلّم والاستكشاف عند الأطفال. فكيف يمكننا أن نعيد الحماس داخل الصفّ ونخلق فرص تعلّم نشطة تحرّك أجساد أولادنا بدلاً من جلوسهم في مقاعدهم طوال النهار؟
إذا وضعت نفسك مكان طفلك اليوم، ستجد أنّه محقّ في تهرّبه من الاستيقاظ صباحاً فقط ليكرّر الأفعال اليوميّة نفسها.
-
ضعف الروابط بين المناهج وحياة الطفل اليوميّة يشير الواقع التربويّ في كثيرٍ من بلادنا العربيّة إلى هوّةٍ واضحةٍ بين ما يتعلّمه الأطفال في المدرسة وبين واقعهم اليومي، مما يؤثّر سلباً في دافعيّتهم إلى التعلّم، وفي نظرتهم إلى أهمّيّة المدرسة والفائدة منها سوى لأخذ الشهادة. وهذا ما أكّدته تقارير "اليونيسكو" (2021)؛ إذ إنّ المعلومات التي يدرسونها في معظمها مجرّدة، ولا ترتبط بحياتهم العمليّة، ويؤدي هذا التباعدُ إلى شعورهم بأنّ ما يدرسونَه لا يعكسُ واقعَهم ولا يلبّي حاجاتِهم، ممّا يعزّز إحساسهم بأنّ المدرسة أمرٌ واقعٌ وشرٌّ لا بدّ منه.
-
الخوف والضغط الناتج عن الامتحانات والعلامات تضعُ الثقافةُ المجتمعيّة في بلادنا العلامةَ والدرجةَ في الامتحانات في مرتبةٍ أعلى من التعلُّم نفسه، ممّا يجعل الطفل يربط المدرسة بشعور القلق والخوف من الفشل أكثر من ربطها بحبّ المعرفة والفضول. كما وصُمِّمَت المناهج الدراسيّة التقليديّة بهدف تلقين أكبر قدر من المعلومات للأطفال مع اعتماد الامتحانات كوسيلة أساسيّة لتقييم مستوى تحصيل الطلاب، وبالتالي، مستوى فهمِهم وذكائهم. وقد ولَّد ذلك ضغطاً هائلاً على أبنائنا وحَدَّ من قدرة المدرسة على بناء بيئةٍ تعليميّةٍ ممتعةٍ تشدّهم وتملأ عقولهم وقلوبهم بحبّ التعلّم.
بالإضافة إلى ذلك، تزيد توقّعات الأهل العالية هذا الضغط؛ إذ ينتظرون نتائج الامتحان بشوق وكأنّها نتائجُهم، معبّرين لأبنائهم عن ضرورة الحصول على أعلى العلامات ليفتخروا بهم، وهذا ما جعل الأبناء يخشون الفشل قبل أن يفكّروا بالتعلّم، كي لا يخيّبوا آمال أهلهم ويخفقوا في تحقيق النجاح المطلوب.
ما زاد الطين بلّة، هو التنافسيّة في الصفّ؛ إذ يكون "الأفضل" من يحرز المرتبة الأولى أو العلامة الأعلى، أو يقدم الجواب الأسرع، فالرابح الأوحد يجعل الباقين يشعرون بالفشل إلى حدّ ما؛ لأنّهم لم يسبقوه. وهو نتاج نظام دراسيّ ضاغطٍ لا يكافئُ التعلّم والتقدّم، بل يعزّز الحفظ والاسترجاع خلال الامتحان.
"يُعد كل من التلقين، وعدم ارتباط المضمون الدراسي بالحياة اليوميّة، والضغط الناتج عن التركيز على العلامات، أسباباً جوهريّةً أدّت إلى شعور الطالب بالملل والضيق من المدرسة وأطفأت فضوله ودافعيّته للتعلّم."
أوّل ما يتبادر إلى أذهانِنا هو سؤال: "كيف نجعل المدرسة مكاناً يشتاقُ إليه أبناؤنا؟". فهل تساءلتَ يوماً ما الذي نستطيعُ القيام به نحن الأهل والمعلّمون لكي نحوّل المدرسة من مكانٍ يثير النفور إلى مكانٍ يتشوّق أطفالنا إلى الذهاب إليه كلّ صباح؟ لا يكمن الحلّ هنا في إجبارِهم، أو التحايلِ عليهم، أو حتى إغرائهم بالمكافآت لتقبُّل الواقع المرير، بل في تعزيز دافعيّتهم الطبيعيّة وحبّهم الفطري للتعلّم! في ما يلي أبرز المسبّبات لهذه المشكلة، وبعض الحلول لتفاديها.
ما الأسباب الحقيقيّة وراء نفور أبنائنا من المدرسة؟ نظرة إلى المشكلة من الجذور لكي نجيب عن هذا السؤال، وقبل أن نبحث عن الحلّ، يجب أن نتوقّف ونسأل بصدق عن الأسبابِ الحقيقيّةِ وراء نفورِ الأبناء وعدم حبّهم للمدرسة. فهل المشكلة في المدرسة بحدّ ذاتها كمؤسّسة؟ أم في ضعف تحفيز الأهل لأولادهم كفايةً؟ أم في أسلوب تعامل المعلّمين مع الطلاب؟
كشفت دراسة ضخمة أجرتها جامعة "ييل" في عام 2020 أنّ قُرابة 75% من طلاب المرحلة الثانوية، أبدوا مشاعر سلبيّة تجاه المدرسة، بما في ذلك الملل والتعب والقلق، مما يؤكّد أنّنا نواجه أزمةً حقيقيّةً في دافعيّة أبنائنا إلى الدراسة، وقد يكون للأهل دورٌ غير مقصود في تعزيز هذا النفور.
في ما يلي أبرز الأسباب التي تؤدّي إلى تملمُل أبنائنا من المدرسة.
- التركيز على الحفظ والتلقين بدل التعلّم النّشِط ما تزال المناهج التعليميّة في معظم مدارسنا تعتمد على أحاديّة التواصل في الصفّ؛ إذ يوجّه المعلّم التعليمات، ويشرح الدرس، ويطرح الأسئلة للطلاب بدلاً من اعتماد أسلوب الحوار والاستكشاف والتجربة، ممّا يُفقد الأطفال شغف التعلّم، فيشعرون بالملل والضغط.
تخيَّل أن تقضي سبع ساعات يومياً في مكان لا يحفّز تفكيرك؛ حيث تستمع إلى محاضرات متتالية، وتحلّ واجبات متشابهة إلى حدّ كبير، وتشعر وكأنَّك تعيد اليوم ذاته طيلة العام الدراسي.
يُعد هذا الشعور بالملل خطيراً؛ لأنّه يُطفئ الفضول والدافعيّة الفطريّة للتعلّم والاستكشاف عند الأطفال. فكيف يمكننا أن نعيد الحماس داخل الصفّ ونخلق فرص تعلّم نشطة تحرّك أجساد أولادنا بدلاً من جلوسهم في مقاعدهم طوال النهار؟
إذا وضعت نفسك مكان طفلك اليوم، ستجد أنّه محقّ في تهرّبه من الاستيقاظ صباحاً فقط ليكرّر الأفعال اليوميّة نفسها.
-
ضعف الروابط بين المناهج وحياة الطفل اليوميّة يشير الواقع التربويّ في كثيرٍ من بلادنا العربيّة إلى هوّةٍ واضحةٍ بين ما يتعلّمه الأطفال في المدرسة وبين واقعهم اليومي، مما يؤثّر سلباً في دافعيّتهم إلى التعلّم، وفي نظرتهم إلى أهمّيّة المدرسة والفائدة منها سوى لأخذ الشهادة. وهذا ما أكّدته تقارير "اليونيسكو" (2021)؛ إذ إنّ المعلومات التي يدرسونها في معظمها مجرّدة، ولا ترتبط بحياتهم العمليّة، ويؤدي هذا التباعدُ إلى شعورهم بأنّ ما يدرسونَه لا يعكسُ واقعَهم ولا يلبّي حاجاتِهم، ممّا يعزّز إحساسهم بأنّ المدرسة أمرٌ واقعٌ وشرٌّ لا بدّ منه.
-
الخوف والضغط الناتج عن الامتحانات والعلامات تضعُ الثقافةُ المجتمعيّة في بلادنا العلامةَ والدرجةَ في الامتحانات في مرتبةٍ أعلى من التعلُّم نفسه، ممّا يجعل الطفل يربط المدرسة بشعور القلق والخوف من الفشل أكثر من ربطها بحبّ المعرفة والفضول. كما وصُمِّمَت المناهج الدراسيّة التقليديّة بهدف تلقين أكبر قدر من المعلومات للأطفال مع اعتماد الامتحانات كوسيلة أساسيّة لتقييم مستوى تحصيل الطلاب، وبالتالي، مستوى فهمِهم وذكائهم. وقد ولَّد ذلك ضغطاً هائلاً على أبنائنا وحَدَّ من قدرة المدرسة على بناء بيئةٍ تعليميّةٍ ممتعةٍ تشدّهم وتملأ عقولهم وقلوبهم بحبّ التعلّم.
بالإضافة إلى ذلك، تزيد توقّعات الأهل العالية هذا الضغط؛ إذ ينتظرون نتائج الامتحان بشوق وكأنّها نتائجُهم، معبّرين لأبنائهم عن ضرورة الحصول على أعلى العلامات ليفتخروا بهم، وهذا ما جعل الأبناء يخشون الفشل قبل أن يفكّروا بالتعلّم، كي لا يخيّبوا آمال أهلهم ويخفقوا في تحقيق النجاح المطلوب.
ما زاد الطين بلّة، هو التنافسيّة في الصفّ؛ إذ يكون "الأفضل" من يحرز المرتبة الأولى أو العلامة الأعلى، أو يقدم الجواب الأسرع، فالرابح الأوحد يجعل الباقين يشعرون بالفشل إلى حدّ ما؛ لأنّهم لم يسبقوه. وهو نتاج نظام دراسيّ ضاغطٍ لا يكافئُ التعلّم والتقدّم، بل يعزّز الحفظ والاسترجاع خلال الامتحان.
"يُعد كل من التلقين، وعدم ارتباط المضمون الدراسي بالحياة اليوميّة، والضغط الناتج عن التركيز على العلامات، أسباباً جوهريّةً أدّت إلى شعور الطالب بالملل والضيق من المدرسة وأطفأت فضوله ودافعيّته للتعلّم."
- دمج التعلّم بالحياة اليوميّة لا يبدأ التعليم في المدرسة ولا يتوقّف على أبوابها؛ فالحياة هي المدرسة وهي البيئة الطبيعيّة لتعلّم الأطفال. كما يُعد دورُ الأهل في ربط ما يتعلّمُه الأطفال في المدرسة والحياة اليوميّة أسهلُ ممّا يتصوّره كثيرون، خصوصاً عند الصغر؛ إذ يكون الفصل بين المدرسة والبيت ما زال محدوداً في ذهن الأطفال. وهناك عديدٌ من المواقف والأمثلة التي يمكن من خلالها للأهل دمجَ التعلّم النظريّ بالتطبيقيّ.
مثلاً، عند الذهاب للتسوّق، اطلب من طفلِك حسابَ ثمنِ الأغراض ومقارنة الأسعار والأوزان لاختيار الأنسب، ثم احتساب المجموع والقيام بالدفع واسترداد الباقي، وذلك ليتدرَّب على استخدام الرياضيات في الحياة اليوميّة. أما إذا كانت دراسته عن النباتات، فاصطحِبه إلى الحديقة أو المشتل وعرِّفه على أنواع مختلفة من الأعشاب والزهور، واجعله يختار نبتةً ليشتريها ويعتني بها في البيت. وإن كان الدرس عن النجوم والكواكب، اخرج ليلاً برفقته وشاهدها معه، وابحث عن التشكيلات النجميّة، وقارنها مع ما في الكتاب.
كذلك، ساعده على تطوير استراتيجيّات دراسيّة ممتعة باستعمال بطاقات، أو ألعاب مراجعة، أو مسابقات قصيرة. فبدلاً من اختبار شفهي جادّ، إجعل المراجعة لعبة "من سيربح المليون" داخل البيت. كل ذلك لأنّ الربط بين التعليم في المنزل والمدرسة، يجعل التعلّم ممتعاً، وواقعيّاًً، ومتواصلاً في وعي الأطفال، ويقضي على فكرة منتشرة بكثرة وهي أنّ المدرسة عالمٌ منفصلٌ عن الواقع والحياة.
- اكتشافُ المواهب وتنميتُها خارج المنهج الدراسيّ لا تقتصرُ حياة الأطفال على المدرسة فقط؛ فهي وإن كانت تأخذُ الحيّزَ الأكبرَ من وقتِهم، وجهدِهم، وتفكيرِهم، وعلاقاتِهم، إلا أنّ هناك كثيرٌ من الأمور التي على الأهل متابعة القيام بها، والتأكُّدِ من وجودِها في حياة أطفالهم لكي ينموا نموّاً متوازناً وصحّياً، ومن ضمنِها تنميةُ مواهبهم في المجالات كافّةً.
فلا يمكن أن ننتظر من المدرسة أن تكتشف مواهب أبنائنا وتغذّيها؛ لأنّ هذه مهمّتنا كأهل، وعلينا تشجيعُهم على استكشاف الهوايات التي يحبّونَها وممارستِها بانتظام. فالفنون، كالرسم والموسيقى، أو الرياضة، أو الشطرنج، وغيرها من الهوايات، ليست فقط فرصةٌ للترفيه أو تمضيةِ الوقت خلال الإجازة المدرسيّة كما يظنّ البعض، إنَّما هي فرصةٌ ثمينةٌ لتنمية القدراتِ الذهنيّةِ والإبداعيّة؛ إذ تعزّز الصحّةَ النفسيّةَ وتخفّف التوتّر، وتساعد على بناء المهارات الحياتيّة والاجتماعيّة كتكوين الصداقات والتعاون مع الآخرين.
دور المعلّم والمدرسة: بناء بيئة تعليميّة محفّزة "المعلّم العادي يلقّن، والجيّد يشرح، والمتفوّق يبرهن، أمّا العظيم، فَيُلهِم." - وليام آرثر وارد (كاتب ومربّي أميركي).
بعد أن استعرضنا دور الأهل ومسؤوليّتهم في تحفيز الدافعيّة للتعلّم لدى أبنائهم، لا بدّ الآن من التباحث في دور المعلّم والمدرسة، خصوصاً أنّ الأطفال يمضون معظم يومهم هناك. لذا، للمعلّم الدور الأكبر في جعل المدرسة مكاناً يُحبّه الأطفال من خلال تشكيله التجربة التعلّميّة اليوميّة لهم داخل الصف.
وفقاً لأبحاث تربويّة حديثة، مثل تقارير المسح الدولي للتعليم والتعلّم الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, TALIS 2021)، التي تقيس بيئة التعلّم من منظور المعلّمين والقادة التربويّين، ودراسات من جامعات "هارفرد" و"كامبريدج" حول أثر المناخ الصفّي في تحفيز الدافعيّة لدى الطلاب، فإنّ أهمّ 3 مسؤوليّات للمعلّم في جعل الأطفال يحبّون المدرسة هي كالتالي:
1. بناء علاقة آمنة مع الطلاب تعزّز فضولهم وتشجّعهم للمشاركة الفاعلة لا يتعلّم الطفل أو يستمتع بالمدرسة إن كان يشعر بالخوف، أو التوتّر، أو التهديد، أو السخرية. فالمعلّم هو المسؤول عن بناء بيئة آمنة يسودها الاحترام المتبادل ويشعر فيها الطفل أنّ المعلّم يعرفه جيّداً ويفهمه، وأنّه محبوب وأنّ جهده مقدَّر، فيزداد تفاعله مع المادّة التعليميّة ويتعزّز شعوره بالانتماء الى المدرسة. كما ويحتاج الطفل إلى من يشجّعه على السؤال والمحاولة دون الخوف من العقاب أو السخرية إذا أخطأ. ومن الهامّ أن يحفّز المعلّم الأسئلة والمداخلات من الطلاب مهما كانت بسيطة أو سطحيّة، ويتقبّلها برحابة صدر، ويتفاعل معها، ويشكر الطلاب على مشاركة أفكارهم. فمع التكرار والمثابرة، ينكسر حاجز الخوف وينطلق الأطفال بفكرهم إلى مساحات أوسع وأعمق.
إليكم بعض الأمثلة البسيطة التي يمكن للمعلّم استخدامها لبناء الألفة مع طلابه وفي ما بينهم. مثلاً، أن يستقبل الطلاب بابتسامة، ويذكر أسماءهم عند التفاعل معهم، فيشعر كلّ طفل أنّه مرئيّ وهامّ. أو أن يخصّص دقيقةً مثلاً في بداية الحصّة ويختار طالب مختلف كلّ مرّة ليُخبر عن شيء شخصيّ كهواية أو إنجاز بسيط أنجزه.
كذلك، يمكن للمعلّم أن يحضّر بطاقات تشجيعيّة كتبَ عليها عبارات دعم، مثل: "أعجبتني مساعدتك رفيقك اليوم" أو "أظهرتِ حماساً رائعاً في مشاركتكِ في الدرس"، ويوزّعها على الطلاب خلال الأسبوع. فالعلاقة الآمنة تُبنى من خلال تفاصيل صغيرة يستشعر من خلالها الطالب صدق المعلّم ومحبّته، فيتحوّل الصفّ إلى بيت ثانٍ بالنسبة إليه.
إقرأ أيضاً: كيفية التعامل مع الأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة 2. جعل التعلّم حيّاً ومرتبطاً بحياة الأطفال يُعد التلقين أو الإلقاء الجامد طريقةً مملّةً وقديمةً ولا تجدي نفعاً في العمليّة التعليميّة. ومع ذلك، ما زالت تُستخدم في كثيرٍ من الصفوف في بلادنا العربيّة. فقد أظهرت الدراسات أنّ الطفل يحبُّ كلّ ما يثير فضوله الطبيعي، فيشعر أنَّه يخصُّه ويشبه عالمه فيزداد حماسه للتفاعل معه. وهذا ما يحدث عندما يربط المعلّم الدروس بتجارب عمليّة وقصص من الحياة اليوميّة، بالتالي، تتحوّل المعلومات النظريّة إلى أنشطة تعليميّة محفّزة ضمن مشاريع جماعيّة مبنيّة على التعاون والمشاركة مع الأقران، أو إلى رحلات ميدانيّة خارج الصفّ تتيح للطالب ربط ما يتعلّمه من الكتاب بتجارب حقيقيّة.
تجعل هذه النشاطات البيئة التعلّميّة حيويّةً وممتعة، وتزيد نسبة الاحتفاظ زيادةً كبيرةً، وتُشعِر الطلاب أنّهم يشاركون في التعلّم، وليسوا متلقّين فقط.
3. بناء شراكة حقيقيّة مع الأهل يُعد التواصل الفعّال مع الأهل أساس بناء شراكة متينة وحقيقيّة معهم؛ إذ وضعَ الأهل أبناءهم أمانةً بين يديّ المعلّم والمدرسة، فأصبحوا شركاء في تربيتهم وتعليمهم ورعايتهم، وفي دعم نموّهم الفكري، والمعرفي، والعاطفي، والاجتماعي. بالتالي، شكّل البيت والمدرسة فريقاً واحداً ومتكاملاً في حمل هذه الرسالة وخلق بيئة مناسبة لصقل شخصية الأبناء وعقولهم وقلوبهم.
لتحقيق ذلك، يجب على المدرسة فتح مجال التواصل المستمرّ مع الأهل، من خلال إرسال رسائل إخباريّة أسبوعيّة أو شهريّة، عن طريق البريد الإلكتروني أو تطبيق مخصّص مثلاً، تتضمّن ملخصاً عن أحداث ماضية وقادمة، ونصائح حول تحفيز الطلاب في المنزل، أو من خلال مكالمات إيجابيّة يشارك فيها المعلّمون إنجازات الطالب، بالتالي، هم لا يتّصلون فقط عند وجود مشكلة كما هي العادة. يساعد هذا على بناء جسر الثقة بين المدرسة والأهل لتقبّل الملاحظات مستقبلياً.
كما يمكن أن تنظّم المدرسة دورات تعليميّة للأهل حول كيفية استخدام الأدوات التكنولوجيّة التي يستخدمها الطلاب، أو حول إدارة الفروض المدرسيّة في البيت، أو دعوة الأهل للمشاركة في النشاطات المدرسية، كالاحتفالات الثقافية أو أيام النشاطات الرياضية، أو حتى للمساعدة في تنظيم حديقة المدرسة. فعندما يشعر الأهل بأنَّهم جزء من المجتمع المدرسيّ، تزداد دافعيّتهم للمشاركة ويرتفع حسّهم بالانتماء للمدرسة كعائلة.
إقرأ أيضاً: 6 نصائح تُساعد طفلك للذهاب إلى المدرسة بدون خوف في الختام الأهل هم الذين يزرعون بذرة حبّ التعلّم في البيت، لكنّ من يسقيها يوميّاً هو المعلّم داخل الصفّ. إذا اجتمع دور الأهل في التشجيع، مع دور المعلّم في خلق بيئة آمنة وممتعة ومحفّزة، فتتحوّل المدرسة بحقّ إلى مساحة نموّ واكتشاف ينتظرها الأطفال بشغف.
لتكن البداية الجديدة من هنا؛ غيِّر اليوم نظرتك إلى المدرسة وشارِك طفلك رحلة التعلّم، وتذكَّر أنَّ الخطوات الصغيرة ستصنع تغييراً كبيراً.