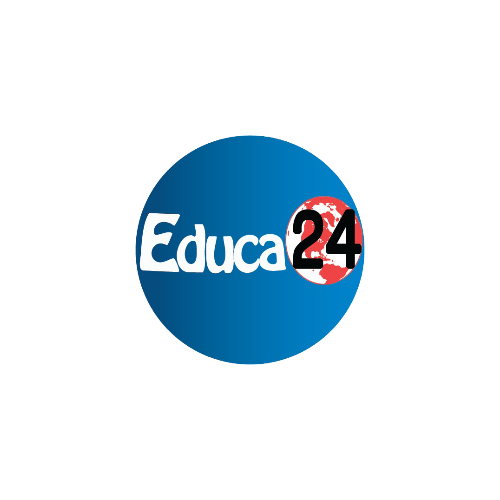فالتربية في بعدها الجيوسياسي، لا تعمل على المدى القصير، فهي ليست قرارا دبلوماسيا ظرفيا، ولا مناورة عسكرية آنية، بل هي عملية تراكمية بطيئة، قد لا تظهر نتائجها إلا بعد عقود، لكنها ترسخ في الوعي الجمعي تصورات قد تحدد مسار الأحداث السياسية لاحقا، ولعل ذلك ما يفسر اهتمام القوى الكبرى بقطاع التعليم بوصفه ساحة استراتيجية موازية للسياسة الخارجية. الولايات المتحدة على سبيل المثال، لم تكتف بانتصارها العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، بل استثمرت في صياغة مناهج تعليمية تؤطر النموذج الأمريكي ، وتصدر قيم الديمقراطية الليبرالية، وتجعل من الحلم الأمريكي خطابا عالميا، والصين بدورها جعلت من التربية أحد أعمدة مشروعها الحضاري، من خلال معاهد كونفوشيوس المنتشرة عبر القارات، والتي تقدم اللغة والثقافة الصينية ليس فقط كمعارف، بل كدعامة رمزية لتمدد نفوذها الدولي.
ما يكتسب خطورة أكبر، هو أن المناهج الدراسية تصبح في حالات معينة جبهات للصراع الرمزي، ففي جنوب آسيا مثلا، يظل النزاع الهندي-الباكستاني حاضرا في الكتب المدرسية من خلال خرائط متناقضة لإقليم كشمير، وفي اليابان والصين، تتجدد التوترات كلما ناقش الطرفان كيفية تدريس أحداث الحرب العالمية الثانية، وفي العالم العربي، تتأرجح سرديات التاريخ والجغرافيا بين تأكيد الشرعيات الوطنية وتجاهل السرديات المشتركة. هذه الأمثلة تكشف أن الصراع على الورق قد لا يقل تأثيرا عن الصراع على الأرض، لأن الوعي الجماعي الذي يبنى في المدرسة، يحدد كيف يفهم المواطنون حاضرهم وكيف يتصورون مستقبلهم.
من هذا المنطلق، تبدو المناهج الدراسية قادرة على إنتاج قوة ناعمة تمهد للنفوذ السياسي والاقتصادي، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالمدرسة قد تسهم في تثبيت هوية وطنية، لكنها قد تقع في فخ إعادة إنتاج السرديات المغلقة، التي تقوي التماسك الداخلي لكنها تضعف القدرة على التفاعل الإيجابي مع المحيط، وهنا يطرح النقد نفسه: هل يكفي أن ترسخ المناهج خطابا وطنيا دفاعيا لمواجهة الخصوم، أم أن المطلوب هو بناء وعي مرن، قادر على تثبيت الهوية من جهة، والانفتاح على الهويات الأخرى من جهة ثانية ؟
الحالة المغربية تقدم نموذجا غنيا لهذا النقاش، فمنذ الاستقلال عملت المدرسة المغربية على ترسيخ صورة الدولة الوطنية الموحدة، وإبراز تاريخها العريق وموقعها الجغرافي المتميز، ومع مرور الوقت، توسع هذا الأفق ليشمل إبراز البعد الأمازيغي والإفريقي والمتوسطي في الهوية الوطنية. هذا التوجه يحسب للمغرب، لأنه يحاول الجمع بين التعددية الداخلية والانفتاح الخارجي، لكن في المقابل يظل الطموح التربوي في كثير من الأحيان أكبر من القدرة العملية على تحقيقه، فالمناهج رغم تعديلات متكررة، ما تزال في نظر كثير من الباحثين بطيئة في مواكبة التحولات الدولية: فهي تركز على تثبيت سرديات تقليدية أكثر مما تستثمر في إعداد المتعلمين لمواجهة تحديات العولمة الرقمية، أو التحولات المناخية، أو الصراعات الجديدة حول الذكاء الاصطناعي والموارد غير التقليدية.
كما أن المدرسة المغربية ما تزال تعاني من فجوة واضحة بين الخطاب المعلن والسياسات الفعلية.. فمن جهة، تؤكد الوثائق الرسمية على التربية على قيم الانفتاح والكونية، ومن جهة أخرى يظل التلميذ متأثرا ببرامج دراسية يغلب عليها الطابع التلقيني والوصفي، مما يقلل من قدرته على التحليل النقدي والتفكير الاستراتيجي. هذه الفجوة تحد من إمكان تحويل المناهج إلى أداة فعالة في بناء قوة ناعمة إقليمية، فحتى لو رسخت المدرسة هوية وطنية متماسكة، فإنها قد لا تنجح في إنتاج جيل قادر على توظيف هذه الهوية في علاقاته الخارجية، سواء عبر الدبلوماسية الثقافية، أو من خلال ريادة فكرية إقليمية.
النقد هنا لا يعني أن المغرب غائب عن استثمار البعد التربوي جيوسياسيا، بل يشير إلى أن هذا الاستثمار يظل جزئيا وغير متكامل، فبرامج مثل أكتشف تراث مدينتي ؛ أو إدماج اللغات الأجنبية؛ أو الانفتاح على التاريخ الإفريقي هي خطوات مهمة، لكنها تبقى محصورة في نطاق تربوي داخلي، فلكي تتحول المناهج إلى رافعة جيوسياسية حقيقية، لا بد من ربطها بشكل أوثق بالدبلوماسية الثقافية والسياسات العمومية في مجالات أخرى، بما يجعل المدرسة عنصرا في منظومة متكاملة لإنتاج النفوذ الرمزي.
وعلى المستوى النقدي أيضا، يطرح سؤال جوهري حول طبيعة السرديات التي تبنيها المناهج المغربية، فبينما تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، فإنها قد تغفل أحيانا أهمية الانفتاح على التعددية في سياقها الكوني، فالمطلوب ليس فقط أن يقتنع التلميذ بشرعية قضيته الوطنية، بل أن يمتلك أيضا أدوات معرفية وحجاجية تسمح له بالدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية، وهذا يقتضي إعادة النظر في طرق تدريس التاريخ والجغرافيا والفلسفة، بحيث تتحول من مواد تلقينية إلى فضاءات للنقاش النقدي وإنتاج المعنى.
خلاصة القول: إن جيوسياسة التربية تكشف عن بعد جديد في فهم القوة في القرن الحادي والعشرين، فالتوازنات الإقليمية لم تعد تبنى فقط على ما هو عسكري أو اقتصادي، بل أيضا على ما هو رمزي وثقافي، والمدرسة بما تزرعه من قيم ورؤى ورموز، تحدد إلى حد بعيد موقع الدولة في محيطها، وتسهم في صياغة صورة مستقبلها، ومع ذلك، فإن فعالية هذا الدور تظل رهينة بمدى قدرة السياسات التربوية على الجمع بين حماية الخصوصية الوطنية والانفتاح على الكونية، وبين ترسيخ الهوية وتوسيع آفاقها.
إن المغرب بتراثه التاريخي والثقافي، يملك إمكانات لا بأس بها من أجل تحويل المدرسة إلى أداة استراتيجية لصناعة النفوذ، غير أن هذا يتطلب شجاعة أكبر في تحديث المناهج، وجرأة في إدماج القضايا العالمية الجديدة، وتنسيقا أوثق بين التربية والدبلوماسية الثقافية. حينها فقط يمكن أن ننتقل من مدرسة تكرر سردية دفاعية إلى مدرسة تنتج سردية إبداعية، قادرة على أن تجعل من المغرب فاعلا إقليميا لا يكتفي بالدفاع عن شرعيته، بل يصوغ رؤيته الخاصة للتوازنات الإقليمية.