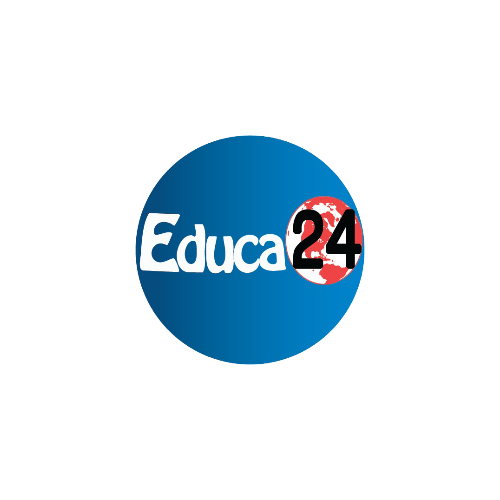كان الدخول المدرسي في عهدنا، وبالخصوص في عهد من سبقونا يحمل من الرمزية والثقل ما لا يحمله يوم آخر، ففيه يتحدد مصير التلميذ من حيث الصف الذي سيدرس فيه، ومن حيث المدرسين الذين سيحملون على عاتقهم مهمة إخراجه من ظلام الجهل إلى نور العلم. كانت المدرسة بالنسبة لي أيام الطفولة المتزامنة مع نهاية حقبة التسعينيات، مؤسسة قائمة بوجودها وحضورها الدائمين، كنا في تلك الأيام الباردة والبعيدة مقارنة بما يحصل اليوم في دنيا الناس، أقل تكلفة وأكثر حلما. كانت المستلزمات الدراسية صغيرة على مستوى الكم، كبيرة على مستوى الكيف، لازلت لحد الساعة أتذكر أن أول شيء أقوم به حينما أشتري الكتب المدرسية، الذهاب بلهفة إلى النصوص المسترسلة ألتهمها التهاما، ثم يخيب ظني حينما يضعون نقطة النهاية لحظة بداية مشهد مثير، وينهونها بعبارة كنت أمقتها بشدة: "بتصرف"
كانت النصوص المسترسلة المقتطفة من أعمال أدباء كبار، سواء من مشرق الأرض أو من مغربها، تثير فيّ ذلك الحس التخيّلي الذي لا تكتمل معالمه سوى بحضور من علّمونا دون شرط، وأخص بالذكر معلمي الأول في الأدب جرجي زيدان ثم المنفلوطي وطه حسين ونجيب محفوظ ومحمود تيمور... كانت هذه النصوص المسترسلة مبرمجة على مستوى توزيع الزمن التعلُّمي خلال نهاية السنة الدراسية، ومن ثمة فقد يحدث أحيانا أن يتصرف فيها المعلم فلا يستغل منها إلا النزر القليل. أما في الفرنسية، فقد كنت أسير بلهفة نحو أشعار فيكتور هيجو الذي أعطانا لمحة شاعرية عن فرنسا القرن التاسع عشر وبودلير وعباراته المعقدة ورامبو ورموزه الثقيلة... أستمتع بإيقاعها الرخيم قبل أن أفهم بعض كلماتها.
كانت الكتب المدرسية سواء المتعلقة بمادة العربية أو الفرنسية، موسوعة في الأدب بكل أصنافه، غنية بتعدد أعلامها الكبار الذين مروا على مختلف الحقب التاريخية، أما بخصوص الرياضيات مثلا أو الفيزياء، فقد كان المُدرس يضعنا خلال كل درس أمام الشروط الابستيمولوجية ـ من حيث لا يدري ـ التي وُجدت عن طريقها وبفضلها هذه المبرهنة أو النظرية، مما كان يضعنا في سياق الحدث وأسبابه قبل أن يُسهب في شرح الدرس. حقا لقد كانت فرصة مناسبة للتعرف على ماضي الإغريق المجيد، بدءا من قصة الهرم مع طاليس، إلى دافعة أرخمديس وعبارته الشهيرة أوريكا، مرورا بالفتح الرياضي المُبين الذي جاء ما فيتاغوراس...
لم تكن الدروس تنتهي في الصف، بل كانت مرافقنا الأول والأخير في الطريق رفقة جواد وسفيان وياسين.. كنا نتنافس فيما بيننا من يمكن أن يقدم معلومة حول الدرس الفلاني، لكن خارج ما جاء في الكتاب المدرسي، والغريب في الأمر أن هؤلاء الأصدقاء استطاعوا الجمع بين الميل العلمي والثقافة الموسوعية على المستوى الأدبي. حقا لقد كانت نقاشاتنا تصب فيما يمكن القيام به بعد ذلك، كان الشرط المحدد لعلاقتنا شرطا يتطلع لما سيأتي، وليس لما قد وقع. ثم سيحدث انقلاب مفاجئ في مسيرتي العلمية حينما سأتعرف على فرويد خلال السنة الثانية من التعليم الإعدادي، ومنه سأكتشف الفلسفة مغيرا الحلم من عالم فلكي إلى فيلسوف.
مناسبة هذا القول ليست عرضا لجزء من سيرتي، ولكنه مقارنة بتعليمنا الذي مضى ومضى ثم مضى، وتعليمنا الحالي الجاثم علينا. فما الذي وقع؟
سأتحدث من داخل الإطار: المدرسة المغربية لا تعيش أزمة كما يتم تداوله، والمدرسة المغربية لا تعيش سكتة قلبية كما يلوكه البعض. المدرسة المغربية انتهت وباتت عظامها رميما شهد على ما وقع ذات حقبة، ويشهد بصمت القبور على ما يقع. وحده الله يعلم مآل ما سيقع، وإن كانت المؤشرات تسير وفق نظرة سوداوية للأسف.صحيح أن هناك بعض الانفلاتات، لكنها انفلاتات تُبيّن بالملموس أن المدرسة فقدت رمزيتها المعنوية، وحافظت فقط على حضورها المادي من خلال جدرانها المتسخة، وطاولاتها المهترئة، ونوافذها التي تصلح لأن تكون خلفية لأفلام الحروب والبقاء، خاصة في المناطق التي تعرف كثافة سكانية مهولة. والظاهر أن هذه الانفلاتات تشكل وصمة على جبيننا، لأن المدرسة على المستوى البنيوي كلّ، عناصره مرتبطة فيما بينها، فإما أنها ستصنع أطرا مبدعة في كل المجالات أو لا. ولهذا فإن الانفلاتات ليست صنيعة المدرسة فقط، بل هي صنيعة الجانب العصامي في الفرد، وظروفه المحيطة به أيضا، والتي قد تدفعه إلى التخلص منها بالكد والجد، فتستحيل محركا ودافعا نفسيا من أجل تجاوزه.
حينما أسترق النظر اليوم إلى البرامج الدراسية، لا أنكر أنها تقنية تحاول جاهدا مسايرة العصر، لكنها فارغة شيئا ما من المحتوى، علما أن وضعها كان يجب أن يُستشار فيه الفيلسوف وعالم الاجتماع وعالم النفس ثم رجل التاريخ. لسبب وجيه يكمن في أن المشكل لا يتعلق بالبرنامج الدراسي ولا كتبه المدرسية فقط، بل يتعداها إلى أبعد وأعقد من ذلك، وهو البنية التي لن يفهمها سوى الفيلسوف، والخصوصية والمحيط التي سيفيدنا فيها عالم الاجتماع وعالم النفس بشكل كبير، ثم الظرف وعلاقته بالتراكم التي هي من اختصاص رجل التاريخ، آنئذ سيتم خلق تصور ملائم لبنيتنا وخصوصيتنا وما حققناه من تراكم، وعبره سيتم وضع برامج مدرسية ملائمة لما أنجز فلسفيا واجتماعيا ونفسيا وتاريخيا. أما التقليد الذي نجره اليوم ونحن نتلهف على البيداغوجيات الدخيلة، والبرامج التعلمية القادمة من بيئة مغايرة لبيئتنا، فلا شك أن السير على منواله يشبه الحرث في مياه البحر، ولكم أن تتخيلوا المشهد وسرياليته.
قد تصنع المدرسة مُدرسّا أو مُهندسا أو أديبا أو طبيبا أو قاضيا أو بطلا رياضيا... لكنها صناعة تفتقد إلى الصقل وإلى حس الانفتاح على المجال، وهذا هو السبب الذي يجعل من المُدرس محدودا جدا في مجال اشتغاله، شأنه في ذلك شأن المهندس والطبيب والقاضي والبطل الرياضي... ولنا في طرقنا وقناطرنا ومستشفياتنا وإنجازاتنا الرياضية خير دليل، أماإذا شهدنا بكفاءة أحدهم، فقد تم له ذلك بمثابرته واجتهاده ونبوغه الخاص، والدليل أنه يكفينا أن متعلما بلغ المرحلة الثانوية أو الجامعية حتى، ثم تراه يتلعثم في قراءة نص أو العجز أمام معادلة رياضية أو محاولة فك علاقة فيزيائية. اسألوا أهل الاختصاص كي يحدثوكم أن العديد من المتعلمين يختارون شعبة الاقتصاد ليس حبا فيها، بل هروبا من الفيزياء والرياضيات، واسألوهم مرة أخرى كي يقولوا لكم أن العلاقات الرياضية باتت تُحفظ بدل أن تُفهم. اسألوا أساتذة المواد الأدبية والعلوم الإنسانية في الثانوي والجامعي كي يقولوا لكم أن طالبا مختصا في الأدب الفرنسي مثلا، لم يسبق له أن انغمس في عمل أدبي مرجعي، اللهم إذا تمت برمجته داخل المقرر. اسألوهم واسألوهم كي تعلموا أنه توجب علينا الوقوف طويلا قبل الإعلان الرسمي على الدخول المدرسي..!