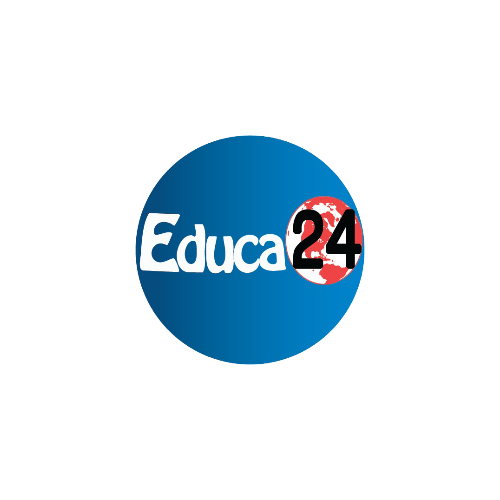أسئلة حارقة حول مدارس الريادة ظلت مثيرة للجدل*.
منذ الاعلان عن الحلقة وموضوعها وقيمة المشاركين فيها حرصت على متابعتها وفي ذهني أكثر من سؤال يحتاج الى توضيح وجواب ،
فظلت أسئلة كبرى مفتوحة لدى المتتبعين والفاعلين طرحها المستشار التربوي الدكتور الحسين الزاهدي في برنامج مثير للجدل على قناة MD1TV
من زاوية الباحث الراصد والمتابع عن قرب قانونيا وبيداغوجيا
على السيد أحمد كريمي مدير التكوينات وتنمية الكفايات بوزارة التربية الوطنية ، كخبير ومسؤول إداري مشرف على تتبع التنفيذ في الميدان
فظلت وغيرها من الأسئلة مطروحة مختومة بعلامات استفهام كبرى دون جواب
وهي كالتالي
ما هو الإطار المرجعي القانوني الذي تأسست عليه تجربة مدارس الريادة الذي يضمن لها الإستدامة والإستمرارية ، وهي تشتغل خارج الأهداف المسطرة في القانون الإطار ومخالفة لمنهجيته في تنزيل الاصلاح ؟
ما هي المعايير التي يتم الاستناد إليها في إدخال مؤسسات تعليمية معينة الى التجربة دون غيرها ، وهل ينبني ذلك على تقييمات مسبقة لهذه المؤسسات والفئة التعليمية التي تدرس بها ام أن الاختيارات تفرضها الخريطة المدرسية ومحاولة الوصول الى أكبر عدد من المؤسسات في غياب معايير علمية وبيداغوجية واجتماعية معروفة ومحددة سلفا، وكيف ينعكس هذا الاختيار على نفسية المتعلمين الذين لا ينتمون إلى هذه المؤسسات فيشعرون بنوع من التهميش والحكرة وعدم تكافؤ الفرص ؟
إذا كانت التجربة لم تفتح على الاعدادي في المرحلة التجريبية خلال السنة الماضية إلا في حدود 200 إعدادية من أصل 2000 مؤسسة في التعليم الابتدائي فما مصير التلاميذ الذين مروا بتجربة مدارس الريادة في الابتدائى ولم يجدوا مقعدا لهم بعد ذلك في الاعدادي من أجل الاستمرار في التجربة مما يهدد بعودتهم الى تعثراتهم السابقة لعدم قدرتهم على الاندماج مع زملائهم الذي لم يمروا من نفس التجربة ؟
إذا كانت التجربة تركز على التدريس الصريح وحسب مستوى التلميذ لمعالجة التعثرات التي يعاني منها بعض المتعلمين في القسم فما مصير المتعلمين الذين لا يعانون من هذه التعثرات والذين يوجدون في نفس القسم ونفس المؤسسة ؟
إذا كانت التعلمات تركز على مواد بعينها ، فما مصير باقي المواد المكونة المنهاج بما تتضمنه من أنشطة والتي تنمي لدى المتعلمين مهارات مهمة كالقدرة على التحليل والتصنيف والمقارنة والتركيب والاستنباط وإبداء الرأي وغيرها من المهارات التي تكون شخصية المتعلم ؟
كيف يتم التعامل في الامتحانات الإشهادية مع فآت من المتعلمين لا يخضعون لنفس المنهاج التعليمي ؟
إذا كانت التجربة ناجحة حسب
تقييمات الوزارة فلماذا لم تطبقها في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ولو على سبيل التجريب ؟
هل تضمن التجربة الانصاف والتكافؤ الفرص في ظل وصول نسبة التسرب والهدر المدرسي والتفاوتات المجالية الى مستويات مقلقة ؟
إذا كان عدد المؤسسات التعليمية يصل إلى ما يقرب من 13 الف مؤسسة في الوقت الذي ينتظر أن تصل فيه التجربة خلال نهاية هذه السنة الى 4 ألف مؤسسة أي الثلث بمعدل 2000 مؤسسة في السنة فمتى سيتم التعميم على9000 مؤسسة الباقية وهل سيدخل التجريب الى الثانوي التأهيلي أم سيقف عند عتبة الإعدادي لتعود حليمة الى عادتها القديمة في الثانوي ؟
ما هي الدلائل المرجعية للتقييم والجودة والأطر الوطنية للإشهاد التي يحتكم إليها في تقييم المشروع تقييما علميا محايدا يطمأن إليه في ظل غياب إخراج هذه الدلائل التي جاء بها القانون الإطار ؟
ما مصير التجربة في ظل تقييم المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي خلص الى أن المشروع برمته غير قابل للتعميم نظرا لكلفته ومتطلباته المادية والبيداغوجية المرتفعة في ظل مردودية غير مضمونة ومستدامة؟
غياب جواب واضح عن هذه الأسئلة الكبرى المؤطرة المشروع ، بعيدا عن الإغراق في التفاصيل الإجرائية البيداغوجية والتقنية في الميدان والتي يحتاج قياس أثرها على التعلمات ونتائجها على المدى المتوسط الى تقييمات علمية محايدة ، خلف لدى الرأي العام مزيدا من الضبابية حول واقع المشروع ومستقبله واستدامته ، وهو المشروع الذي راهنت عليه الوزارة والحكومة بوضوح لانقاذ رصيدها في تنزيل الإصلاح في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي (والريادة) ، وذلك في آخر سنة من ولايتها الحكومية
أسئلة كبرى وجوهرية كانت مثيرة للجدل في بداية البرنامج انتظر المتتبعون لورش الاصلاح عنها أجوبة واضحة
فظلت في ختامه أكثر إثارة للجدل.